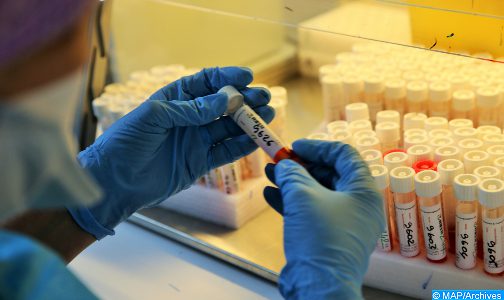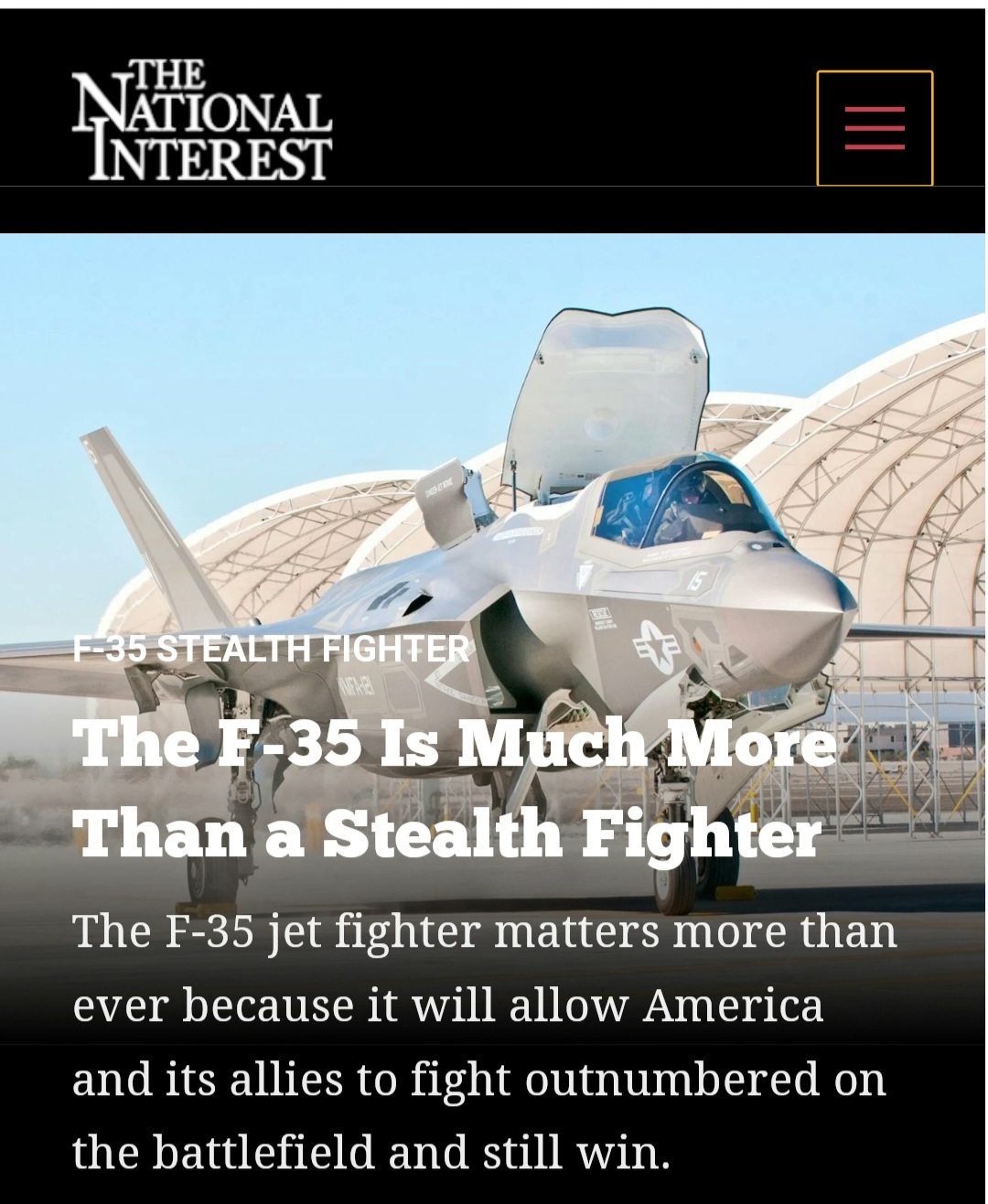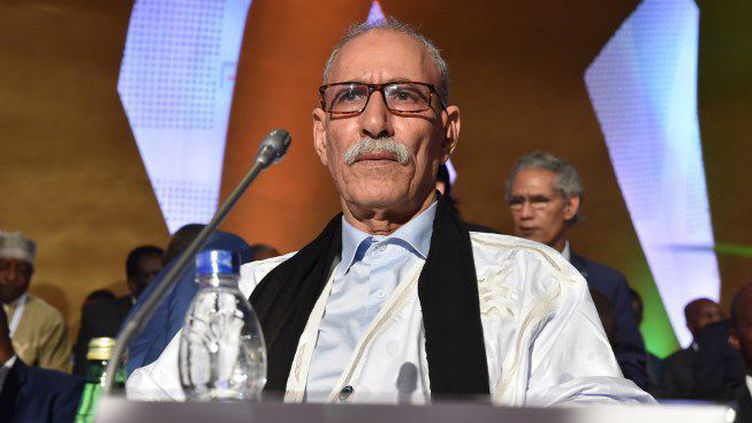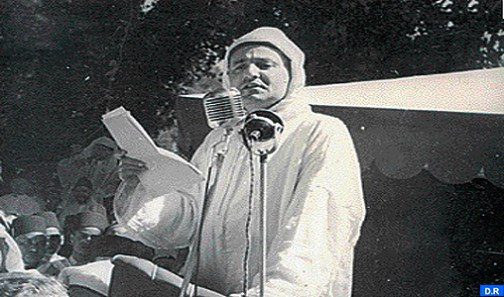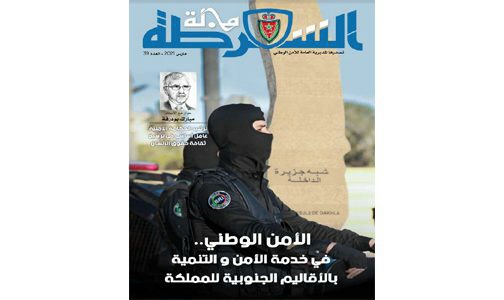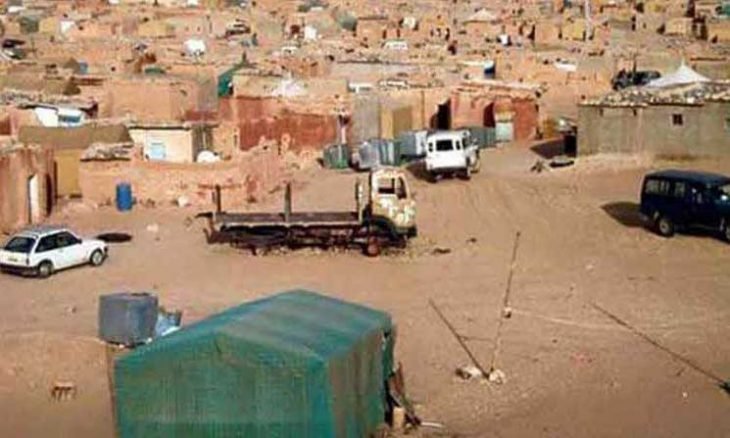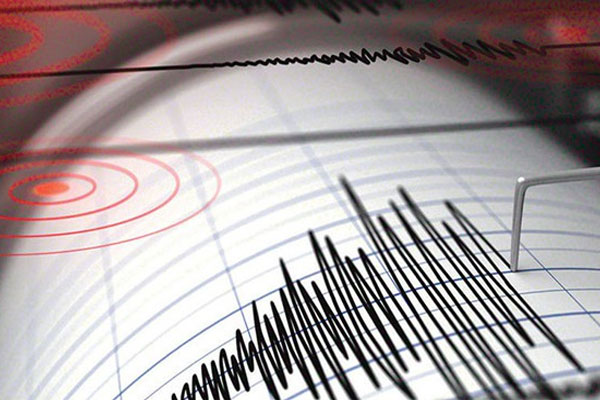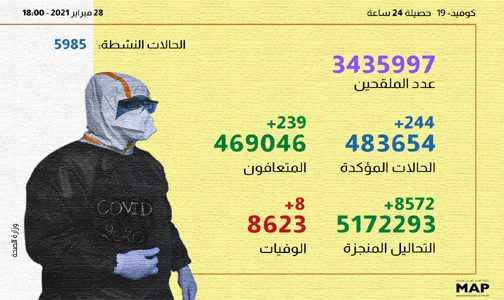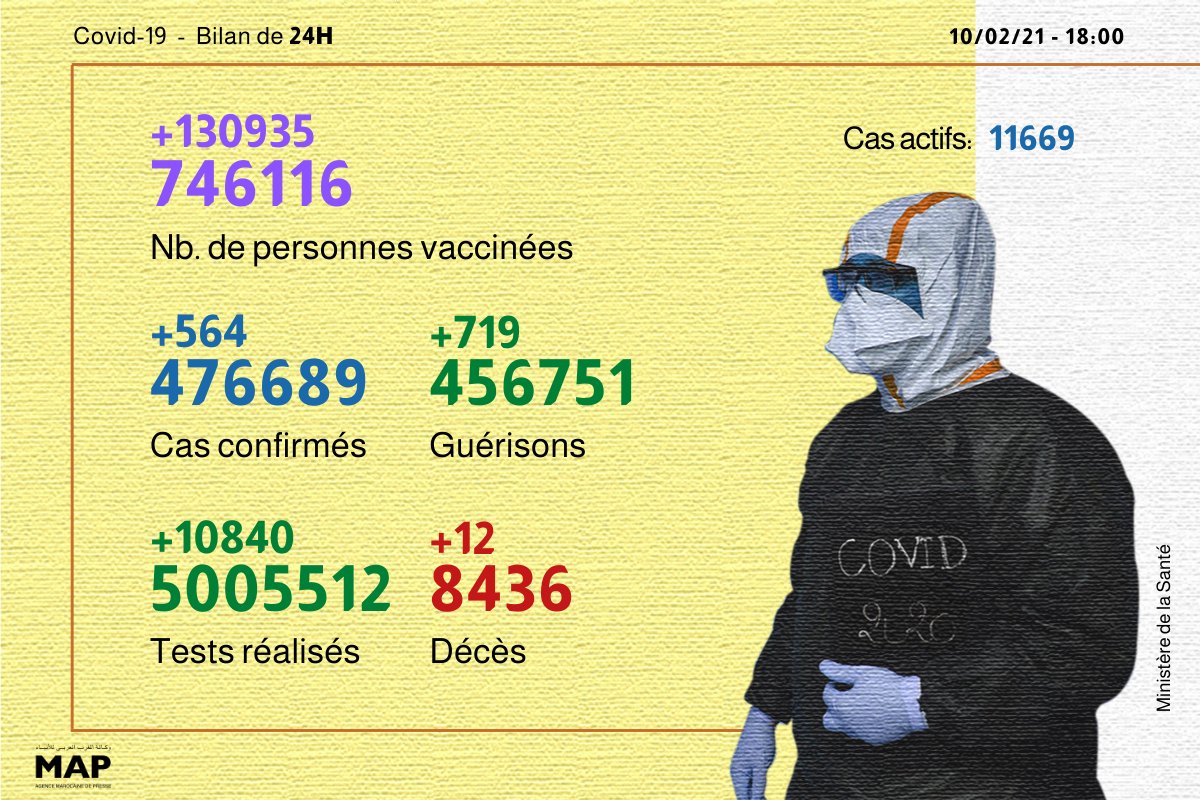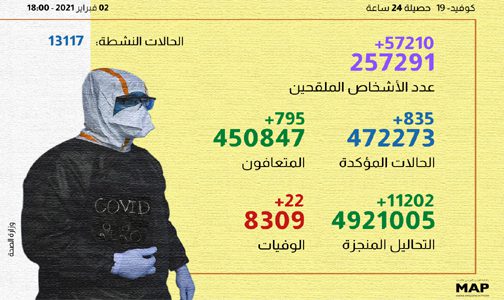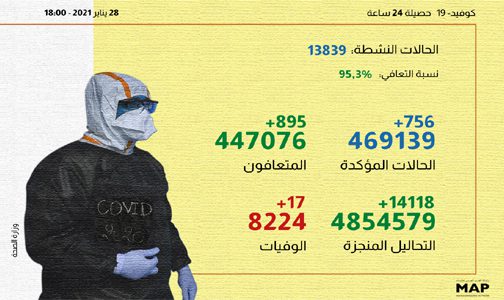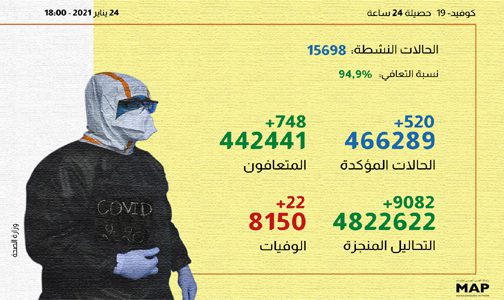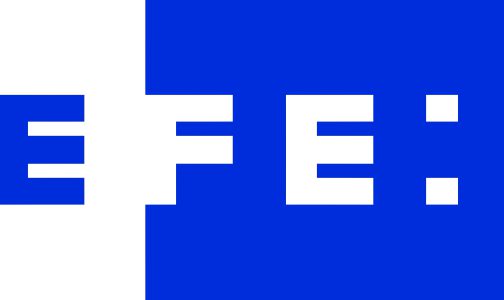بتعليمات ملكية سامية: مؤسسة محمد الخامس للتضامن تطلق العمل بـ13 مركزا جديدا في عدد من مدن المملكة
بقلم أحمد الشرعي

في خضم الاضطرابات التي تعصف بالشرق الأوسط المعاصر، وبينما تعاد صياغة خريطته تحت وطأة تحوّلات استراتيجية كبرى، تدور معركة أخرى، أقلّ ظهورًا، لكنها لا تقلّ مصيرية: معركة الضمائر.
إن الضربات الدقيقة التي تُوجَّه إلى إيران، في مسعى لاحتواء تهديدها النووي وكبح جماح نظامها الاستبدادي ذي النزعة التوسعية، إلى جانب تفكيك شبكات حزب الله المسلحة، وتكثيف الضغط على أذرع طهران في المنطقة — كل ذلك يدلّ على منعطف جيواستراتيجي لا رجعة فيه. لقد انتهى زمن التساهل الاستراتيجي، وبدأت مرحلة جديدة لا يجرؤ البعض على الاعتراف بها بعد.
وفيما النظام الإقليمي القديم يترنّح، والدبلوماسية تعيد ابتكار أدواتها تحت ضغط الواقع، لا تزال عقول متحجّرة تتشبث بشعاراتها البالية، وسردياتها المتحجرة. وفي ظل هذا الجمود، هناك من يختار مهاجمة أولئك الذين يفكرون بطريقة مختلفة، بدلًا من مساءلة صُنّاع الحروب الحقيقيين.
هؤلاء لا يسعون إلى نقاش، بل إلى فرض وصاية أيديولوجية، وإقامة محاكمات أخلاقية دون استئناف.
بعد ساعات قليلة فقط من مجزرة فظيعة تفيض وحشية، نشرت مقالًا بعنوان: “كلّنا إسرائيليون” في مجلة The Jerusalem Strategic Tribune، الصادرة من واشنطن.
كان العنوان استفزازيًا عن قصد، لا لزرع الانقسام، بل للتعبير عن نبضة إنسانية خالصة. جاء في سياق انتفاضات تضامنية عالمية، مثل “كلنا أمريكيون” بعد أحداث 11 سبتمبر، أو “أنا شارلي” عقب اعتداءات باريس.
لم يكن المقال موقفًا سياسيًا، ولا انحيازًا أيديولوجيًا، بل كان صرخة ضمير في وجه اللامعقول. لم يكن الهدف الانحياز لطرف على حساب آخر، بل تذكير بحقيقة بسيطة: حين يُذبَح المدنيون — نساءً، وأطفالًا، وشيوخًا — ويقابل ذلك بالصمت أو الغموض الأخلاقي، فإنما يُذبَح فيهم الإنسان للمرة الثانية.
موقفي لم يتغيّر قط. لقد دافعت دومًا، وبلا تردّد، عن الحق الثابت للشعب الفلسطيني في الكرامة، وتقرير المصير. دولة فلسطينية، كما يراها الفلسطينيون أنفسهم، شكلًا ومضمونًا، تعيش إلى جانب دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها.
لم أساوم يومًا على هذا المبدأ: العدالة للفلسطينيين ليست بندًا تفاوضيًا، بل شرطًا لا غنى عنه لأي سلام حقيقي، دائم، ومُعترف به من الجميع.
ومع ذلك، في زمن يُفترض فيه أن تكون الكلمة الحرة أساسًا لنقاش ناضج، هناك من يفضّل الشتيمة على الفكرة. يدّعون حراسة الأخلاق العامة، ولا يجيدون سوى لغة الشك — والإهانة. وبغياب الحجة، يلجؤون إلى الهجوم الشخصي، مستخدمين تعابير نابية واستعارات حيوانية، لتشويه ما لا يستطيعون دحضه بالمنطق.
هؤلاء لا يتحاورون. بل يُشيرون بالأصابع. لا يُنتجون فكرًا. بل يصنعون أعداء. يتقمصون دور قضاة الضمائر، كأنهم يملكون حقّ الحُكم على الناس.
لكن زمن التكفير الأيديولوجي قد ولى. قال فيكتور هوغو، في لحظة نفاذ بصيرة: “أتريد حرية الفكر؟ ابدأ بعدم كراهية من يفكر بخلافك.”
لم يكن هذا التذكير يومًا أكثر إلحاحًا. تُبنى الأمم الراسخة، المتصالحة، والمتطلعة إلى المستقبل، بتعدد الأصوات لا بقمعها.
أما أولئك الذين يسعون، اليوم، إلى استثمار معاناة الشعوب لتسجيل نقاط سياسية على حساب كرامة الآخرين، فإنهم يخونون ليس فقط عدالة القضية الفلسطينية، بل وذكاء جمهورهم نفسه.
فالشعوب ليست ساذجة. وهي تُفرّق تمامًا بين الالتزام الصادق والاستغلال الانتهازي.
أما أنا، فسأستمر في الكتابة. سأدافع عن الكلمة الحرّة. وسأتمسّك بمواقف قد تُزعج، لكنها لا تخون المبادئ.
سأبقى مؤمنًا بإمكانية شرق أوسط متصالح، متسامح، ومزدهر.
وأمّا التاريخ، فسيلعب دوره. وكما هو دائمًا: ما يبقى بعد ضجيج الاتهامات، ليس صخبها، بل صفاء فكرٍ مستقيم.